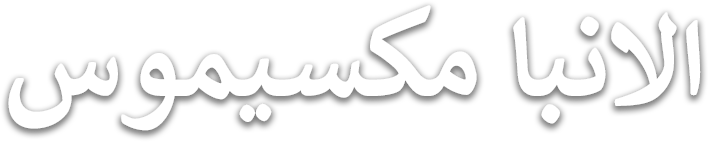استمع الي الراديو من هنا
التفكير ليس ممنوعًا (١٠) | هل يسمع الله أنين المحتاج؟
القصة التي سأبدأ بها حديثي معكم اليوم، لا علاقة لها بي شخصياً من بعيد، ولا من قريب، ولا بكنيستي، التي تعتقد بالمعجزات ومواهب الروح القدس. ولكن قد حكتها لي أم واحد من الشباب الذين كنت مكلفاً برعايتهم في مدينه طنطا، طبعاً في شبابي؛ وصاحبة هذه القصة لم تكن من أبناء الكنيسة في طنطا، ولكنها كانت من الكادحين من أبناء شعبنا الصابر.
كانت تعول خمسة أطفال لا يمتلكون من حطام الدنيا سوى جلابيه من الدَّمور يلبسونها على العري؛ وكانت حينما تريد أن تغسل جلاليب أطفالها الخمسة، تختار يوماً مشمساً إذا كان شتاء، ويجلس الأطفال الخمسة عرايا في الشمس، حتى تنشف جلاليبهم!
وكان زوجها عامل التراحيل، قد ذهب ليشتغل في السد العالي، ولم يعد من هذه البعثة بعد. وذهبت هذه المرأة الكادحة إلى السيدة التي حكت لي قصتها، لتقترض منها قروشاً حتى تشتري خضار من الحقل وتبيعه في السوق، وتحقق هامشاً من الربح لتشتري به خبزاً لأطفالها الخمسة (كان رغيف الخبز بخمسة مليمات آنذاك).
وفيما هي سائرة بين الحقول برفقة واحدة من قريباتها؛ فإذا بغراب يحضر بمنقاره أرغفة ساخنة، ويلقيها إلى جوار شجرة كبيرة في الطريق، ثم يغيب الغراب ويعود برغيف آخر وهكذا؛ فاندفعت الفقيرة الجائعة إلى الخبز الساخن لتأكل منه، فقالت لها قريبتها: لا تأكلي من الخبز لئلا يكون قد رُش عليه توكسافين (مبيد حشري لدودة القطن)
فأجابتها المسكينة: لأموت بالتوكسافين، ولا أموت من الجوع. ثم ملأت حجرها بالخبز الساخن، وعادت به إلى أطفالها، وذهبت بالتالي إلى جارتها، لترد لها القروش التي كانت قد استعارتها منها وتروي لها هذه القصة.
اخترت هذه القصة من عشرات المعجزات والتدخلات الإلهية في حياه الناس، على مدى خدمة طولها نصف قرن من الزمان، لأن لها دلالات مهمة، أريد أن أبرزها.
إن هذه المرأة لم تكن واحدة من الرهبان أو الراهبات النساك، ولم تذهب إلى واحد من رجال الله القديسين المشهود لهم بالتقوى، تطلب منه المعونة أو الصلاة لأجلها. ولا أعرف بالضبط ماذا كانت تعرف هذه المرأة عن الله، وماذا تعرف عن الصلاة والإيمان وكل هذه الأمور؛ لكن القصة تشهد بأن الله كان يعرفها، وكان يسمع أنينها، ويشعر بألم جوعها، وحاجتها، وإنه تدخل بطريقة عملية لإغاثتها وإشباعها.
في لاهوت الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، والكلام على لسان القديس مكسيموس المعترف: إن هنالك عملاً للروح القدس في البشر قبل المعمودية والإيمان، أي خارج الكنيسة والإيمان!
والتاريخ مليء بأمثال هذه القصص من معاملات روح الله القدوس مع الإنسان، من الفرعون الجالس على عرش أعظم ممالك الدنيا إلى الفقراء، والبسطاء، والمحتاجين، والمتضايقين في كل مكان.
أعرف جيداً أن هذا النوع من الخطاب، يتصادم مع مراكز القوي الدينية على تنوع واختلاف أديانهم، وإنه يختلف اختلافاً جذرياً عن منطق التنشئة الدينية، التي يُنشأ عليها أبناء المتدينين جميعاً: أنهم هم وحدهم وبسبب إيمانهم ودينهم هذا، الذين يستحقون استجابة الله لصلواتهم وتدخله في حياتهم.
أعرف بالخبرة العملية من خلال نشأتي في مجتمع الصراع بين الأديان، كرجل دين منذ نعومه أظافري، أن حائط السد المنيع بين محبه الله للإنسان، وبين الإنسان، هم رجال الدين وفتاويهم وتفسيراتهم وحجرهم على حريه العقل الإنساني، وأن بداية الطريق هي تحرير العقل الإنساني من القيود التي وضعها عليه هؤلاء المتدينين الذين وقفوا بالباب؛ فلا هم دخلوا ولا تركوا الداخلين يدخلون!
عندي قناعة حقيقية أن العقل الإنساني إذا تُرك حراً من القيود والافكار والموروثات الدينية والاجتماعية؛ فإنه تبعاً لمصداقيته سيجد طريقه لمعرفة الحق، وإنشاء علاقة حميمة وصادقة بين الإنسان؛ وأبوة ومحبة خالقه.
في ختام هذا الحديث، أود أن أخبركم أن شيخ الملحدين "جان بول سارتر" -ومن خلال أكثر مسرحياته إلحاداً- هو الذي واجهني في شبابي بحقيقه تزييف صورة الألوهة على أيدي رجال الدين، فكانت بداية البحث عن الحقيقة حتى وجدتها، وكان التغيير.
من حقك أن تمارس حريتك، وتُعمل عقلك؛ فما من طريق إلى الحقيقة بغير الحرية.
لمتابعة المقالات السابقة من سلسلة مقالات "التفكير ليس ممنوعًا" اضغط عالرابط التالي