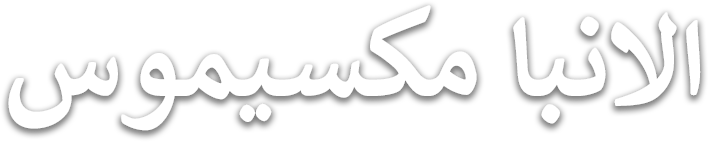استمع الي الراديو من هنا
التفكير ليس ممنوعًا (٩) | لماذا يلحدون!؟
لما أتيت إلى أميركا في المرة الأولى قبل ٣٥ سنة، ذهبت مع مُضيفي لشراء سيارة، ولما كان المبلغ الذي معنا أقل من المطلوب، قلت آنذاك لصديقي بالعربية: ربنا يدبرها، فابتسم بائع السيارات ابتسامة ساخرة؛ فسألته: هل تتكلم العربية؟ فأجاب: قليلاً، سألته: من أين أنت؟ فقال أنه من إيران، قلت حينها: إذن أنت تؤمن بالله. فقال: نعم، سألته: لماذا السخرية من كلامي إذن؟ (ربنا يدبرها) فكان رده: نعم أنا أؤمن بالله، لكن الله لا يفعل شيئاً للبشر!
انتهينا من موضوع السيارة وعدنا إلى المنزل مع صديقي، وقد أحدَّثت العبارة التي سمعتها من البائع استفاقة على واقع حزين يعيشه ملايين البشر من المؤمنين بالله، ويقومون بالفروض، دون أن يختبروا يوماً عناية الله أو محبته ولا استجابة الصلاة.
نحن كرجال دين نتعمق في فقه الأديان، ونخطب الخطب الرنانة ونطلق العظات النارية ونتصور أننا كلما قلنا كلاماً قوياً وعميقاً، فهذا معناه أن السامعين قد استفادوا من وعظنا استفادة كبيرة، غير مدركين أن ما يهم المستمع ليس قوة المعلومات التي احتوتها العظة ولا ضخامة الصوت ولا حيوية الإلقاء؛ لكن ما يهم الإنسان هو: ما الفائدة التي ستعود عليه من بعد هذا الكلام؟ أو ما الذي يقنعهم بأن يصدقوا ما وُعظوا به؟ أو ما الذي يرغمهم على طاعة التعاليم؟
الأجيال القديمة تربت على الخوف من عصيان الله ومن ناره المشتعلة التي توعد بها العصاة، وكانت تهاب رجال الدين، فكلمة (أنت كافر) أو (أنت محروم من الكنيسة) كانت كفيلة بأن تريه بأحلامه ألسنة النار الأبدية التي تنتظره، مُسببة له الخوف والذعر؛ فضلاً عن فقدانه الاحترام بين ذويه، بسبب رجل الدين الذي كفره أو هرطقة.
هذا الخوف من الله وهذا الوقار لرجال الدين، لم يعد مطلقاً كما كان قديماً، بل صار مقروناً بامتحان مصداقية رجل الدين وكلامه، وصار الإنسان يتساءل، ما فائدة أن أعبد إلهاً لا يفعل شيئاً للبشر!؟
أما التخويف من النار وعذاب جهنم، فلم يعد يحرك إحساس الشباب الغارق في البحث عن مستقبله أو لذاته، فالشباب - بطبيعة سيكولوجيتهم - يعتقدون أن الموت والنار يبعدون عنهم سنين الأجل التي يتصورونها طويلة؛ في أحسن الأحوال سيتظاهرون بأنهم سائرين في ركب العابدين، إراحةً لضميرهم أو لأسرتهم ومجتمعهم؛ بينما السؤال المُلح الذي يدور في داخلهم كل يوم، والذي يجتذبهم بعيداً رويداً رويداً عن ساحة المؤمنين هو: لماذا لا يفعل الله شيئا للبشر؟
رجال الدين يتعاملون مع الملحدين باستعلاء، وينظرون إليهم على اعتبار أنهم من الضالين؛ بينما رجال الدين هم السبب الحقيقي وراء كثرة وزيادة أعداد الملحدين، لأنهم قدموا لهم صورة باهتة لإله غائب مجهول لا يشعر بألآمهم، ولا يجيب على احتياجاتهم؛ ولم يفطنوا إلى أن تغليظ عصا العقوبات والتكفير قد جعلها تفقد قوتها أمام نداء الحرية الذي يجري بعروق الشباب صارخاً في وجوه رجال الدين: كفوا عن استعباد الإنسان وسلب أمواله بخطاب الأوهام والتهديد والوعيد؛ فما عاد هذا الخطاب قادر على أن يقمع نداء الحرية وصوت العقل عند الإنسان.
كنت في شبابي حائراً مثل الباقين، وكنت أريد أن أتأكد من صدق الإيمان وحقيقة الإنجيل؛ أما الذي أوقفني بعمق أمام المسيح خاشعًا، وجعلني قادرًا أن أفصل بين المسيح وبين أتباعه من رجال الدين هي كلمات المسيح: "إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي" (يوحنا ١٠: ٣٧)
فلم أراه غاضبًا أو متنمراً من تشكيك اليهود فيه، بل رأيته يُجيب بمنطق عاقل عملي وهو البرهان بالأعمال، ويؤكد: فإذا لم أبرهن بأعمالي على أقوالي فلا تؤمنوا بي.
هذا هو سبب الفجوة بين الله والإنسان: التناقض بين ما يُقال له عن الله وعن الإيمان به، وبين الواقع الإنساني وشقائه واحتياجاته، دون أي اختبار فعلي أو عملي لأي تدخل إلهي في أحزان الإنسان واحتياجاته الحياتية. فهو لم يحصل إلا على مسكنات الكلام التي يسكنه بها الواعظين، وكذلك لا يرى في حياة رجال الدين صورة التقوى والقداسة الذين يتحدثون بها، بل هم عاجزون أن يبرهنوا بأعمالهم على أقوالهم.
قبل أن تنحنوا باللائمة على شباب أعملوا عقولهم يتساءلون؛ فانحنوا باللائمة على أنفسكم إنكم لا تستطيعون الإجابة على ما يسألون، ولا أن تقدموا برهاناً على ما تقولون.
لمتابعة المقالات السابقة من سلسلة مقالات "التفكير ليس ممنوعًا" اضغط عالرابط التالي