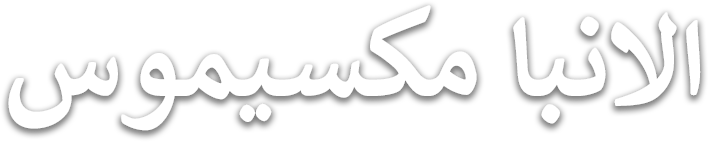استمع الي الراديو من هنا
الفردوس المفقود وجنة النساء
يشرح لنا سفر التكوين: أن الله خلق الإنسان الأول على صورة الله "على صورة الله خلقهما ذكرا وانثي" ووضعهما في بقعة خضراء بهيجة من الأرض هي الجنة، وقال لهما أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض؛ ولذا كان بديهيا أن الحب هو ما يميز الإنسان عن الحيوان في التكاثر؛ فإن المعنى الأكيد لخلقة الإنسان ذكرا وانثي على صورة الله هو قداسة المحبة التي تثمر نمو البشرية.
وعليه فإن سفر التكوين لموسى النبي يقرن سقوط الإنسان في الشر بإحساسه "بالعري" (تك ٧ /٣) الذي لم يكن يحس به قبلا - رغم أنه كان فعلياً عريان - وكذلك "الاشتهاء" (تك ١٧/٣)
وهكذا تحولت حياة وعلاقة الإنسان بالإنسان (الرجل والمرأة) في الجنة من حياة الحب؛ إلى حياة الشقاء والاشتهاء؛ وكراهية الإنسان لأخيه الإنسان بالقتل (تك٨/٤) خارج الجنة!
وهذه هي قصة الإنسان المعاشة، وتحوله من حياة الحب في الجنة إلى حياة الشقاء والكراهية والاشتهاء طردًا من الجنة؛ حتى وإن كانت رواية سفر التكوين رمزية أو تعبيرية!
على أن الإنسان لم يكف من ذلك الحين عن محاولة استعادة الجنة التي كان فيها وطرد منها؛ فجعل من الطبيعة الساحرة - كما الحال في أمريكا- جنة حقيقية على الأرض في مناطق كثيرة؛ لكنه فيما استعاد جمال الطبيعة والأشجار المثمرة وحافظ على الحياة البرية، فقد أطلق العنان بخطة محكمة مدبرة لإغراق المجتمع والإنسان في مستنقع الجنس واللذة موظفاً التقدم الهائل في صناعة السينما والميديا والستالايت لترويج واسع النطاق للجنس واللذة وجنة النساء؛ في محاولة خائبة لتحقيق الفردوس المفقود على الأرض.
ومع ذلك فإنه لم يستطع أن يستعيد البهجة والسعادة التي كانت معه في الجنة، ولا نجح في التخلص من العري والاشتهاء ولا استعاد حياة المحبة! بل والأكثر من هذا صار مدمنا للجنس ومشحوناً من الكراهية والأنانية التي أثمرت الحرب والدمار، ليدمر بيديه وإرادته جنة الأرض التي صنعها الإنسان.
فيما قست الطبيعة والصحراء على الإنسان في أماكن أخرى من الأرض، وانبتت له شوكاً وحسكاً (تك١٨/٣) فقد حرمته من حلم استعادة الجنة، وتركته يحترق بأشعة الشمس ويتحرق بالشوق إلى اشتهاء الجنس؛ بدلاً من المحبة! فصار يحلم بالجنة والفردوس المفقود: بأشجار الفاكهة وبجنة النساء!
فهل نجحت الطبيعة الخضراء المزهرة المثمرة بالعودة بالإنسان إلى الفردوس المفقود؟ وهل استطاعت جنة الجنس والنساء ان تشبع جوع الإنسان وتروي عطشه اللامتناهي إلى الفرح والسعادة؟
حقيقة أساسية غابت عن وعي الإنسان: أن الفرح والسلام الذي افتقر إليه بعد خروجه من الفردوس لا يمكن استرداده إلا بواسطة النور النازل من السماء؛ فمن له هذا النور صار له به الحب والحياة، ومن ليس له النور فمن أين له بحياة المحبة والفرح؟!؛ هذا النور الواهب للحياة هو الجوهر الإلهي الذي حل وتجسد في المسيح يسوع، حتى يشع بنوره على الإنسان اليائس المقهور، فيملأه بالفرح والرجاء والحياة والقوة، يقول المسيح له المجد:
" انا قد جئت نورا الى العالم، حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة.. انا هو نور العالم. من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة" (يو 12: 46 ، يو 8: 12)
هذه هي إشكالية الإنسان المعاصر الذي غادر الحلم بالجنة إلى العمل الجاد لتحقيق الجنة المفقودة على الأرض بكل ادوات المتعة والجنس واللذة؛ محاولاً ان يستعيض عن الفردوس المفقود بجنة النساء! فصار يستقي من آبار مشققة لا تضبط ماءً! ويشرب ماءً لا يروي عطشه؛ بل يزيده عطشًا.
كانت المرأة السامرية التي التقاها المسيح له المجد نموذجاً عملياً لعطش الإنسان الباحث عن فردوسه الضائع؛ قال لها المسيح:
"كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضًا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا (الروح القدس) فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماءٍ (فرح) ينبع إلى حياة أبدية ". (يو ١٤،١٣/٤)