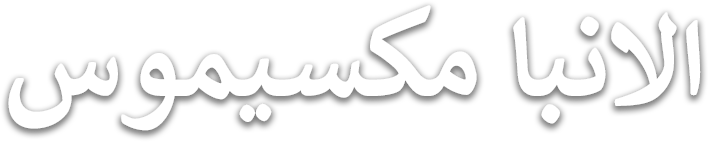استمع الي الراديو من هنا
لاهوت العهد الجديد (١٥) | الشريعة وعطية الحياة بالإنجيل
لا يفوتنا التأكيدُ على أنّ المسيحَ قد أكّد وصادقَ على الشريعةِ المكتوبةِ في لوحي الشريعة (الوصايا العشر)، كنموذجٍ يُحتذى به، وكطريقٍ يؤدّي إلى الله. كما ينبغي أن نؤكّد أنّ موسى النبي كان أميرًا فرعونيًّا مُدرَّبًا على الحُكم والقيادة، وقد أسَّس الديانة اليهودية المعروفة لدينا على أساس استعادةِ بناءِ الأمة اليهودية بعد قرونٍ من العبوديةِ في مصر؛ ولهذا جاءت شريعةُ موسى في إطارِ مزجِ التاريخِ والقوميةِ بالدين والسياسة.
ولأنّ موسى تعلّم وكبِر في مصر، حيث الإلهُ واحدٌ والفرعونُ واحد؛ فقد أتت شريعةُ موسى — التي أرساها في كتابِه الإمام (التوراة) — مؤكِّدةً على وحدانيةِ الإله كصانعٍ للخيرِ والشرِّ (بديلًا لإثنينيّة إلهَي الخيرِ والشر)، ولكنَّها جاءت أيضًا مؤكِّدةً على ديكتاتوريةِ وقمعيةِ الإله والشريعة بنفس تأكيدِها على وحدانيته.
المسيحُ يسوعُ انطلق من قاعدةِ وحدانيةِ الإله، وصادق على الوصايا العشر، لكنه أجرى تعديلاتٍ شاملةً وجوهريةً على شريعةِ موسى النبي؛ خروجًا من الانحصارِ في الأمة والنظام كغايةٍ للشريعة، وانطلاقًا إلى الحرية وكرامةِ الإنسان كغايةٍ واضحةٍ لبشارةِ المسيح (الإنجيل). فعندما قدّموا له امرأةً أُمسِكَت متلبِّسةً بالزنا، وقالوا له إنّ موسى أوصانا أن مثل هذه تُجرَم، أجابهم: "... مَنْ كَانَ مِنْكُمْ بِلاَ خَطِيَّةٍ فَلْيَرْمِهَا أَوَّلًا بِحَجَرٍ!" (يو 8: 7)، وكان يسعى إلى مجالس المهمَّشين والمرفوضين، قائلاً: "... لاَ يَحْتَاجُ الأَصِحَّاءُ إِلَى طَبِيبٍ بَلِ الْمَرْضَى. لَمْ آتِ لأَدْعُوَ أَبْرَارًا بَلْ خُطَاةً إِلَى التَّوْبَةِ." (مر 2: 17)، ثم كان يجول يصنع خيرًا ويشفي المرضى والمتسلّط عليهم من إبليس، ويُشبِع الجموع خبزًا ويسدّد احتياجات الإنسان.
فالشريعةُ التي كانت باسم الله، كانت غايتها الأمة؛ أمّا ثورة التصحيح التي قام بها المسيح (وسُمّيت لاحقًا المسيحية)، فكان غايتها الحرية والإنسان. قال المسيح بوضوحٍ: "... السَّبْتُ (أي الشريعة) إِنَّمَا جُعِلَ لأَجْلِ الإِنْسَانِ، لاَ الإِنْسَانُ لأَجْلِ السَّبْتِ." (مر 2: 27)، وقال أيضًا: "فَإِنْ حَرَّرَكُمْ الابْنُ فَبِالْحَقِيقَةِ تَكُونُونَ أَحْرَارًا." (يو 8: 36)، ومن هنا دُعي إلى علاقةٍ جديدة بين الإنسان والله: أنَّ الله هو الآب السماوي، والمؤمنين أبناءٌ للآب السماوي، ومن ثمّ فإنَّ طاعةَ وصاياه لا بدّ أن تكون ثمرةً للمحبّةِ المتبادلة بين الآب والبنين، وليست بالقهرِ والحديدِ والنار: "إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَنِي فَاحْفَظُوا وَصَايَايَ،" (يو 14: 15).
الرسولُ بولس الذي كان قبلًا فريسيًّا يهوديًّا، عقد مقارنةً بين الشريعةِ والإنجيل على النحو التالي:
1- الشريعة التي أتت لتساعد الإنسان، آلت إلى تأكيد الحكم عليه بالموت؛ بسبب عجزه عن تطبيق الشريعة: "أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ بِدُونِ النَّامُوسِ عَائِشًا قَبْلًا. وَلكِنْ لَمَّا جَاءَتِ الْوَصِيَّةُ عَاشَتِ الْخَطِيَّةُ، فَمُتُّ أَنَا،" (رو 7: 9).
2- أنه بينما كان يسعى الإنسان لطاعةِ شريعة الله، كانت الخطيئة الساكنة فيه تجذبه إلى إتيان الشرِّ دون طاعةِ الشريعة: "وَلكِنِّي أَرَى نَامُوسًا آخَرَ فِي أَعْضَائِي يُحَارِبُ نَامُوسَ ذِهْنِي، وَيَسْبِينِي إِلَى نَامُوسِ الْخَطِيَّةِ الْكَائِنِ فِي أَعْضَائِي." (رو 7: 23).
3- أنّ الشريعة لم تساعد الإنسان في أن يدرك حياة البرِّ والقداسة: "وَلكِنَّ إِسْرَائِيلَ، وَهُوَ يَسْعَى فِي أَثَرِ نَامُوسِ الْبِرِّ، لَمْ يُدْرِكْ نَامُوسَ الْبِرِّ!" (رو 9: 31).
4- أنّ الشريعة أعطت أوامر لإنسانٍ مهزومٍ وخائرٍ دون أن تهبه حياةً وشفاءً من ورطته، فيستطيع أن يطيع الشريعة: "... لأَنَّهُ لَوْ أُعْطِيَ نَامُوسٌ قَادِرٌ أَنْ يُحْيِيَ، لَكَانَ بِالْحَقِيقَةِ الْبِرُّ بِالنَّامُوسِ." (غل 3: 21).
أما عطيةُ المسيح للإنسانِ بالإنجيل فكانت: "... أمّا أنا فجِئْتُ لِتكونَ لهُمُ الحياةُ، بل مِلءُ الحياةِ." (يو 10: 10 ت.ع.م) "وَصِيَّةً جَدِيدَةً أَنَا أُعْطِيكُمْ: أَنْ تُحِبُّوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا. كَمَا أَحْبَبْتُكُمْ أَنَا تُحِبُّونَ أَنْتُمْ أَيْضًا بَعْضُكُمْ بَعْضًا." (يو 13: 34).
بنسلفانيا – أمريكا
١٢ سبتمبر ٢٠٢٥
لمتابعة المقالات السابقة من سلسلة مقالات "لاهوت العهد الجديد" اضغط على الرابط التالي:
https://anbamaximus.org/articles/NewTestamentTheology