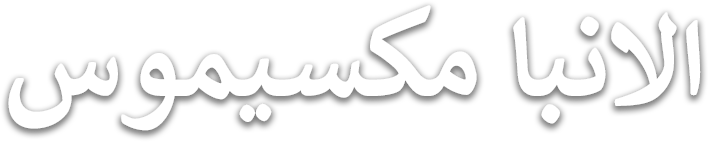استمع الي الراديو من هنا
رأيٌ في الأحداث (۲۷) | الإِيمَانُ لِلضَّمِير، وَالوَطَنُ لِلإِنسَان:
لا يجهلُ أحدٌ من دارسي التاريخ، أن الإمبراطور قسطنطين الكبير قد اتخذ من المسيحية دينًا للإمبراطورية؛ لكي يُوَحِّد شَطري الإمبراطورية الغربي والشرقي، مُستخدمًا تأثيرَ ونفوذَ الدينِ الجديد، وانتشاره الاجتياحي السريع في إمبراطوريته. فالغايةُ كانت سياسيةً بامتياز !، وكذلك لا يُنكِرُ أحدٌ أن الخلفاء العباسيين استخدموا الدينَ الإسلاميَّ بنفسِ الغاية، وهي الحكمُ والسيطرةُ من خلالِ الدين.
مرّت على البشريةِ قرونٌ وعقودٌ طويلة، تُستخدم فيها الأديان كوسيلةٍ للحكمِ والتسلّطِ وقهرِ الإنسان. وكما بالغ باباوات الكنيسة في أوروبا في القهرِ والسيطرةِ وحرقِ الأحياء، فإنه من أوروبا خرجت صرخةُ تحرير الإنسان من سلطانِ الأديان: إنها ثورةُ الحرية: الثورةُ الفرنسية عام 1789، التي حرّرت الإنسان من سلطانِ الدين: من فرنسا إلى كلّ العالم انتشر فصلُ الدين عن الدولة، ولم تعد الدولةُ تحكمُ بالدين، ولا للدينِ تحكمٌ بالدولة؛ حتى صارت الدولةُ العثمانية، التي تحكم بالدين والخلافة، عنوانًا للتخلف الحضاري، حتى أعلن مصطفى كمال أتاتورك عام 1923: "تركيا دولةٌ مدنية".
في تلكَ العصورِ الغابرة، كانَ للدينِ سُلطانٌ ساحرٌ استخدمَهُ الحُكّامُ للفخرِ القوميِّ والشعبوي، وللحُكمِ والسيطرة؛ أمّا الآن، وقد تغيّرَ وجهُ الحياةِ على سطحِ الكرةِ الأرضيّة، وانتشرتْ مبادئُ الحُرّيةِ وحقوقِ الإنسانِ في كلِّ مكان، وصارَ الإنسانُ حرًّا في كلِّ اختياراتِه، حتّى إذا اختارَ أن يتركَ الدينَ نفسَه، كما يحدثُ الآن بعشراتِ الملايينِ في كلِّ أصقاعِ الأرض، فقد صارَ الأمرُ مُثيرًا للدّهشةِ والاستنكار، أنْ ينص دستورُ دولةٍ متعدّدةِ الأديان على أنّ للدولةِ دينًا! كما هو الحالُ في مصرَ وإسبانيا على سبيلِ المثال.
أن يكونَ للدولةِ دينٌ ! فما هو موقفُ الدولة من مواطنيها الذين لا يدينون بدين؟ وما معنى الانتماء إلى الوطن لمواطنين يدينون بخلافِ دينِ دولتهم، ما دام للدولة دينًا؟! أمّا المأساةُ الأليمةُ، بخلافِ ذلك، فهي أنْ إقرار دستور دولة بأن لها دينًا، يُعطي مسوغًا بطريقة غير مُباشرة للجماعات الدينية المُتشددة أن تطمح في الاستيلاء على الحكم باسمِ الدين، وبحقِّ إقرارِ الشريعةِ والدستور ؟! أو كيف يغفلُ أعداؤها عن استخدامِ هذا الفخِّ الناعمِ اللّطيفِ لقلبِ نظامِ الحكمِ متى تعارضتِ السياسات.
لقد صارَ البشرُ يهجرونَ الأديانَ بعشراتِ الملايينِ؛ لأن الدين صار ثِقْلًا وعِبْئًا على حرية الإنسان والضمير؛ فالإيمان مكانه الحقيقي هو حُرّيةُ ضميرِ الإنسان، ومن ثمّ، فإنّ ربطَ نظامِ الدولةِ بالدينِ يعني بالضّرورة أنْ تنالَ الدولةُ من مواطنيها نفسَ المصيرِ الذي يستحقّهُ الدينُ من الإنسانِ في واقعِ عصرِنا الحاضر.
عندي تصوران– من وجهةِ نظري –: إمّا أنْ تكونَ الدولةُ مدنيّةً خالصةً، ترعى مصالحَ المواطنين، وتحترمُ حرّيةَ الأديان، وأنْ يكونَ الإيمانُ مكانَهُ حرّيةَ الضمير، وأنْ تكونَ ممارسةُ الدينِ مكفولةً الحُرّيةِ في دورِ العبادة، ومؤسّساتِها الدينيّةِ الضّابطةِ لها. أمّا التصور الثّاني: فهو أنْ تحاولَ الجماعاتُ الدينيّةُ التستّرَ على زحفِ الإلحادِ، وخروجِ عشراتِ الملايينَ من الدّين، بمحاولة زعزعةِ الاستقرار، والاستيلاءِ على السّلطة.
الجماعاتُ الدينيّةُ المُتشدّدةُ ليستْ قويّةً بالصورةِ التي تدّعيها؛ فهي تُضخّمُ حجمَها وتأثيرَها بوسيلتين: الدّعمِ والضّغطِ السياسيِّ الخارجيِّ المُتواطئِ معها كأداةٍ للتّغيير، وغوغائيّةِ التّجمهرِ بشعاراتِ الدّين. أظنُّ أنّ استفتاءً حرًّا، من خلالِ صندوقِ التّصويت على فصلِ الدّينِ عن الدولة، وحرّيةِ وحقوقِ الإنسانِ والمرأة: سيكشفُ حجمَهم الحقيقيَّ، ويُحقّقُ للمصريينَ عدالةَ الحرّية.
الدينُ للضمير... الوطنُ للإنسان.
بنسلفانيا – أمريكا
۳ مايو ۲۰۲٥
لمتابعة المقالات السابقة من سلسلة مقالات "رأيٌ في الأحداث" اضغط على الرابط التالي: