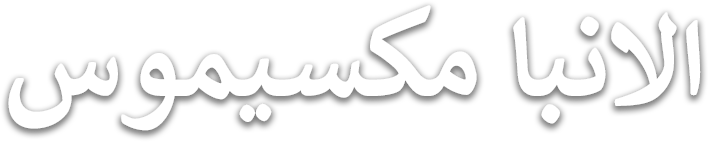استمع الي الراديو من هنا
الفهم؛ ومأساة المخدوعين!
اقتنع الإنسان بوجود إلهين أحدهما خَيِّر والآخر شرير؛ كحل معقول للصراع العميق في الكون بين الخير والشر؛ لكن الرؤية التوحيدية التي أتت بها اليهودية والتي تمددت إلى المسيحية في قطاعات واسعة: حتمت بأن الله الواحد خالق الكون وسيده الأوحد؛ وهو خالق الخير وأيضا الشر؛ هو الشافي من المرض؛ وهو كذلك الذي يجلب المرض عقابًا للعصاة؛ يجلب الفيضان والكوارث الكونية على الأشرار؛ ولكنه أيضا ينجي أبراره المطيعين من الموت والهلاك بنفس الوقت! وهكذا..
ما زاد الأمر صعوبة؛ عقيدة الاختيار والرذل: أن الله الكلي القدرة بسبق معرفته للغيب؛ عرف أن هؤلاء سيكونوا صالحين فأغدق عليهم من العطاء؛ بينما عرف أيضا أن أولئك سيكونوا طالحين فسَوَّد لهم عيشتهم عقابًا على ما هو متوقع! ما يصعب فهمه في هذه الصورة الانفرادية القرار من جانب الإله؛ هو غياب حرية ودور الإنسان فيما يخص الإنسان نفسه! وأن الله المحب الصالح الرحيم هو من يعاقب بهذه القسوة المخيفة!
ليس تأييدًا ولا تشجيعًا؛ ولكن فقط تحليلاً للتاريخ: فإن هذه الصورة التي استعرضناها للألوهة؛ هي المادة التي استند عليها فلاسفة الإلحاد المعاصر! والمؤسف أنهم نسبوا كل هذا إلى المسيحية مع أنها متناقضة معها! ولم يجدوا من يرد عليهم بهذا الرد؛ لأن كنيستهم وقادتهم في عصرهم كانت تفكر بهذه العقلية اليهودية؛ وربما مازالوا كذلك إلى هذا اليوم!
ليس معني قبول المسيحية للعهد القديم واستشهاد الكنيسة بالكلمة النبوية؛ أو أن رب المجد رفض هدمه؛ أنه ليس مختلفًا إلى حد التناقض مع إعلان المسيح عن الآب السماوي ومع عهده الجديد! وهذه هي الخدعة والطامة الكبرى؛ أن البعض وظفوا قبول المسيحية للعهد القديم وعدم هدمه (نقضه) من قبل المسيح له المجد؛ في إقحامه على المسيحية وهدمها من داخلها به؛ لأن مسيحيتهم صارت بإقحام قديمهم على جديدها؛ وعاءًا للمتناقضات! يشهد عليهم العهد الجديد نفسه وشرح الرسول بولس في رسائله إلى روميه وغلاطية والعبرانيين وبعبارات واضحة مثل "الناموس لم يكمل شيئًا" وناموس روح الحياة (الروح القدس) قد أعتقني من "ناموس الخطية والموت" (أي ناموس موسى) وغيرهما الكثير..
محنة ضم تناقضات العهدين القديم والجديد إلى بعضهما؛ ظلت تتمدد من خلال كاثوليكية العصور الوسطى إلى كنائس حركة الاصلاح التي خرجت من رحمها، وإلى الكنيسة المصرية من خلال تأثير إرساليات التبشير الغربية عليها، ولكنها لم تنجح في ذلك في الكنيسة الروسية بسبب حركة التجديد اللاهوتي فيها، ولا في الكنيسة السريانية بسبب عودتها إلى لاهوت الآباء الأولين!
المضحك والمبكي بآن واحد؛ هو أنه فيما كان مجمع الفاتيكان الثاني يجدد لاهوت الكنيسة الكاثوليكية؛ كان تلاميذ الإرساليات الغربية في مصر الذين لم يقرأوا لاهوت الآباء؛ قد تبوأوا مقاليد السلطة في الكنيسة المصرية؛ لكي يوظفوها! في نشر التهود ولاهوت العصور الوسطى اليهودي الفكر، وأيضا القتال من أجله باسم حماية الإيمان المسلم من الآباء؛ الذين لم يعرفوا عن إيمانهم حرفًا واحدًا! الأمر الذي آل إلى تفريغ الكنيسة من حق الإنجيل وقوة الحياة والطبيعة الجديدة؛ باسم وحدة الكتاب المقدس و"الحق الكتابي".
الأكثر سذاجة في هذا المشهد العبثي هو التمسك والبكاء على أطلال البناء المتهدم بمعاول التهويد المنظمة؛ بمحاولة حسني النية نشر أقوال الآباء الأولين لمحاولة ترميم البناء المتهدم؛ بينما المشكلة ليست فقط في رفض تراث الآباء الذي يكشف عوار تعليم معلميهم؛ ولكنه في التأسيس التهويدي للاهوت المسيحي؛ الذي محا الإنجيل تمامًا من لاهوت هذه الكنيسة؛ ولم يبقوا لهم سوى طقوس بلا مضمون وتراث ليتورجي غير مفهوم لأي منهم!
البعض سيعترض على عبارة محو الإنجيل تمامًا؛ لأن الأناجيل متوفرة في أيدي الجميع ويُقرأ أسبوعيًا في كل قداس؛ لأنهم لا يدركون أن جوهر الإنجيل وغاية الحياة المسيحية هي التي طمست وشوهت بإقحام اليهودية وعهدها القديم على إنجيل المسيح وعهده الجديد؛ وليس أن الإنجيل المكتوب هو الذي مُحِيَ؛ إن عدم فهم خطورة إقحام القديم على العهد الجديد؛ هو ثمرة سنوات طويلة من التعليم المُخترق من الصهيونية، ومن الجهل والتجهيل؛ وهو جرس الإنذار أن بلوغ النهضة والتغيير ما يزالان على مسافة بعيدة جدًا!