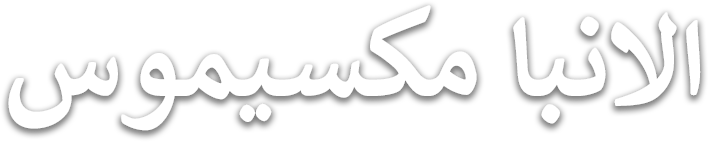استمع الي الراديو من هنا
رأيٌ في الأحداث (۲۹) | عصرُ الحريّةِ والرأي:
لما كنتُ في سنِّ الثلاثين، راودتنيٍ رغبةٌ في إصدار مطبوعٍ شهريٍّ بنفس العنوان لخدمة الشباب المسيحي، يحتوي على مقالاتٍ مخصصةٍ لهم. وحين علمتُ أن إصدار مطبوعٍ دوريٍّ بنفس العنوان غير مسموح به إلا بتصريحٍ من هيئة الاستعلامات المصرية، توجَّهتُ إليها لطلب الترخيص، لكن مديرها عاملني بازدراء. خرجتُ من عنده بقرارٍ أن أصدر المطبوع بعنوانٍ جانبي هو "مقالات للشباب"، وأن أكتب على الغلاف اسم أول مقال، وأضيف إليه بخط صغير عبارة "ومقالات أُخرى". واستمر هذا المطبوع بنفس الفكرة، ولكن بعنوانٍ مختلف، يصدر عن بيت التكريس، حتى بعد أن غادرته.
وحين صرت في أربعينيات العمر، وكنتُ قد أنشأتُ مبنى لمؤسسة القديس أثناسيوس بالمقطم، طلبتُ من مهندسي الكمبيوتر أن يساعدوني في بث عظاتي عبر الإنترنت. فكانت الإجابة: "هذا أمرٌ صعب التنفيذ جدًا، وسيكلّفك مبالغ طائلة، ولن يكون البث ناجحًا كما تتوقع !"
أما اليوم، فقد تغيَّر العالم وتطوَّرت التكنولوجيا بشكلٍ هائلٍ ومخيف، حتى أصبح مُتاحًا لأي إنسان أن ينشئ قناةً تليفزيونية على اليوتيوب أو على أيٍّ من وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، ويعبّر عن رأيه كما يشاء في إطار القواعد التي تنظّمها جهة البث. وبهذا صار متاحًا للمعارضين السياسيين، وكذلك المبشِّرين من مختلف الأديان، وأيضًا المفكرين، أن يعبّروا عن آرائهم من خلال السماوات المفتوحة ووسائل التواصل الاجتماعي، ويصل صوتهم إلى كل أصقاع المسكونة في خلال عشرين ثانية على الأكثر. كما أصبح بإمكان أي شخص أن يسافر من بلده إلى أي من البلاد التي تبيح حرية الفكر والنشر، وينشر عبر الإنترنت ما يشاء من أفكار.
الأفكار العجائزية التي يسعى إليها البعض للاحتماء بسلطة الأنظمة الحاكمة من النقد السياسي أو من التبشير، صارت مثيرةً للشفقة وأيضًا للسخرية؛ لأنها تشبه دعاة التسلح بالسيوف والرماح -التي استخدمها يشوع بن نون للاستيلاء على الأراضي- في عصر الصواريخ والطائرات.
العصر الذي نعيشه هو عصر الحرية، ومقاومة الفكر بالفكر، ومواجهة النقد بالإصلاح والتغيير؛ إذ لم يعد ممكنًا لأي سلطة، دينية كانت أو زمنية، أن تفرض رأيها على الناس بأساليب القمع الهمجية التي كانت سائدة في عصور العبودية وقهر الإنسان، ولا بالسيف والرماح، بل بإقناع العقل وبرهان المنطق والدليل. فمغادرة الأديان إلى غيرها أو إلى الإلحاد ليست ظاهرةً خاصةً بدينٍ معيّن أو بشعب دون غيره؛ فما يحدث في مصر يحدث أيضًا في كل العالم في الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية في أوروبا وأمريكا، التي فقدت ٤٠٪ من تابعيها، وأغلبهم من الشباب، في آخر إحصاء.
الحل ليس في مقاومة الحرية بالغطرسة، بل في عقلنة الخطاب الديني، وأنسنته، وعصرنته، وتجديده بأسلوبٍ يتناسب مع عقل الإنسان المعاصر ويلبي تطلعاته ونضجه وتطوره. أما التمسك بأسلوبٍ قديمٍ عتق وشاخ وعفا عليه الزمن، فلن يجدي نفعًا.
إن أي محاولة لزعزعة استقرار الدولة المصرية من خلال استنفار الصراع الديني الطائفي بين المسلمين والمسيحيين لن تجد صدى سوى السخرية والاستهجان بين المصريين؛ لأن الوعي الإنساني قد نما ونضج، وتأكد الجميع من خلال تجربة سنة حكم الإخوان المسلمين: أن هؤلاء أقليةٌ تسعى إلى السلطة باسم الدين، ولا يشكلون القاعدة الشعبية المصرية؛ فصندوق الاستفتاء والتصويت هو من سيكشف الحقيقة.
اسمحوا لي أن أكرر دقَّ جرسِ الإنذارِ لما قلتُه مرارًا وتكرارًا في هذه السلسلة والمقالات: إنَّ شقَّ وحدةِ المصريين بواسطةِ الطائفيةِ الدينية هو الفرصةُ السانحةُ على طبقٍ من فضةٍ لتحقيقِ حلم "من النيل إلى الفرات".
بنسلفانيا – أمريكا
۱۲ مايو ۲۰۲٥
لمتابعة المقالات السابقة من سلسلة مقالات "رأيٌ في الأحداث" اضغط على الرابط التالي: